المفعول المطلق
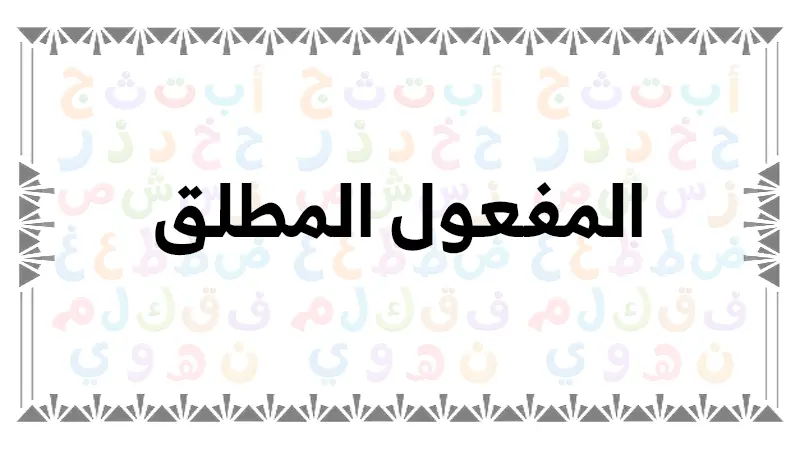
مقدمة
تتميز اللغة العربية بدقتها وإيجازها في التعبير، ومن بين الأدوات النحوية التي تحقق هذا الإيجاز والوضوح يبرز “المفعول المطلق”. لا يُعد المفعول المطلق مجرد اسم منصوب يُضاف إلى الجملة الفعلية، بل هو مصدر مشتق من الفعل نفسه، يأتي لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده. إنه أسلوب بلاغي ونحوي فريد يُضفي على الكلام قوة وتأثيرًا، ويُعمق فهم المتلقي للحدث وخصائصه. فهم أنواع المفعول المطلق ووظائفه المختلفة، وعلامات إعرابه، يُعد ضروريًا لإتقان قواعد النحو العربي والتعبير عن المعاني بدقة وجمالية. إن دراسة المفعول المطلق تكشف عن عمق العلاقة بين الفعل ومصدره في اللغة العربية وعن قدرة هذه اللغة على التعبير عن دقائق الأحداث وتفاصيلها.
قد يُستخدم المفعول المطلق لإبراز أهمية الفعل وشدته، أو للتعبير عن الاستمرار والتكرار، أو لإضفاء نبرة خاصة على الكلام. كما أن حذفه في بعض السياقات قد يُوحي بالكثرة أو الشدة بشكل ضمني. لذا، فإن فهم المفعول المطلق يتجاوز مجرد معرفة تعريفه وأنواعه ليشمل إدراك أبعاده البلاغية وقدرته على إيصال المعاني بتأثير قوي وموجز. إن الاستخدام الواعي والملائم للمفعول المطلق يُعد علامة من علامات التمكن من اللغة العربية وفنونها البلاغية.
تعريف المفعول المطلق وأهميته في اللغة العربية
المفعول المطلق هو مصدر منصوب مشتق من لفظ الفعل، يأتي في الجملة الفعلية لعدة أغراض: توكيد الفعل، بيان نوعه، أو بيان عدده. يُعد المفعول المطلق من المنصوبات في اللغة العربية، وهو عنصر هام يُساهم في دقة التعبير وجمالية الأسلوب.
أهمية المفعول المطلق:
- توكيد الفعل: يُستخدم لتأكيد وقوع الفعل وتقويته في ذهن السامع أو القارئ.
- بيان نوع الفعل: يُبين كيفية وقوع الفعل وهيئته وصفته.
- بيان عدد مرات وقوع الفعل: يُحدد عدد مرات حدوث الفعل.
- الإيجاز والدقة: يُمكن أن يُلخص المفعول المطلق معنى الجملة أو يُضيف إليها دقة في التعبير.
- التأثير البلاغي: يُضفي على الكلام قوة وتأثيرًا خاصًا.
أنواع المفعول المطلق ووظائفها
ينقسم المفعول المطلق إلى ثلاثة أنواع رئيسية حسب وظيفته في الجملة:
- المؤكد للفعل (التوكيدي): يأتي هذا النوع لتأكيد وقوع الفعل وتقويته، ولا يصف الفعل أو يُبين عدده. غالبًا ما يكون مطابقًا للفعل في حروفه الأصلية. أمثلة:
- ضربتُ اللصَّ ضربًا. (تأكيد وقوع الضرب).
- كلمتُهُ تكليمًا. (تأكيد وقوع التكليم).
- سارَ الجنديُّ سيرًا. (تأكيد وقوع السير).
- المبين للنوع (البياني للنوع): يأتي هذا النوع لبيان كيفية وقوع الفعل وهيئته وصفته. غالبًا ما يُوصف أو يُضاف إلى اسم آخر يُبين نوعه. أمثلة:
- ضربتُ اللصَّ ضربَ الأسدِ. (بيان نوع الضرب).
- سارَ الجنديُّ سيرًا حثيثًا. (بيان نوع السير).
- قرأتُ الكتابَ قراءةَ المتفحصِ. (بيان نوع القراءة).
- المبين للعدد (البياني للعدد): يأتي هذا النوع لبيان عدد مرات وقوع الفعل. قد يكون مصدرًا يدل على العدد (مثل مرة، مرتين، ثلاث مرات) أو اسمًا يدل على العدد (مثل ضربة، ضربتين، ضربات). أمثلة:
- ضربتُ اللصَّ ضربةً. (بيان عدد مرات الضرب).
- قفزَ اللاعبُ قفزتينِ. (بيان عدد مرات القفز).
- سجدَ المؤمنُ سجداتٍ. (بيان عدد مرات السجود).
أحكام المفعول المطلق النحوية وعلامات إعرابه
- النصب: المفعول المطلق دائمًا منصوب.
- علامات النصب: يعرب المفعول المطلق بعلامات النصب الأصلية والفرعية نفسها التي يُنصب بها الاسم:
- الفتحة: إذا كان مفردًا أو جمع تكسير. مثال: ضربتُ ضربًا، قرأتُ قراءاتٍ.
- الياء: إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم (نادرًا ما يأتي جمع المذكر السالم مفعولًا مطلقًا). مثال: سرتُ سيرتينِ.
- الكسرة النائبة عن الفتحة: إذا كان جمع مؤنث سالم. مثال: سجدتُ سجداتٍ.
- الألف: إذا كان من الأسماء الخمسة (نادرًا ما يأتي المفعول المطلق من هذه الأسماء).
حذف المفعول المطلق (جوازًا ووجوبًا)
قد يُحذف المفعول المطلق من الجملة في بعض الحالات:
- الحذف الجائز: يُحذف المفعول المطلق جوازًا إذا دل عليه دليل في الكلام أو كان مفهومًا من السياق. أمثلة:
- قال تعالى: “فاضربوهنَّ” (تقديره: ضربًا).
- سرتُ سيرًا طويلًا، وسأسيرُ (تقديره: سيرًا).
- الحذف الواجب: يجب حذف المفعول المطلق في بعض الحالات، منها:
- إذا كان نائبًا عنه اسم إشارة يدل على نوعه. مثال: ضربتُهُ ذلكَ الضربَ. (نائب المفعول المطلق: ذلك).
- إذا كان نائبًا عنه صفة المصدر. مثال: سرتُ أحسنَ السيرِ. (نائب المفعول المطلق: أحسن).
- إذا كان نائبًا عنه العدد. مثال: ضربتُهُ عشرينَ ضربةً. (نائب المفعول المطلق: عشرين).
- إذا كان الفعل يدل على نوع المصدر. مثال: قعدَ جلوسَ الأميرِ. (المفعول المطلق محذوف وجوبًا لأنه دل عليه الفعل).
- إذا كان الفعل يدل على عدده. مثال: رميتُهُ رميةً. (المفعول المطلق محذوف وجوبًا لأنه دل عليه الفعل).
- في بعض التعبيرات السماعية. مثال: حمدًا للهِ. شكرًا لكَ.
أمثلة تطبيقية على استخدام المفعول المطلق وإعرابه
- المؤكد للفعل:
- دافعَ الجنديُّ عن وطنهِ دفاعًا. (دفاعًا: مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مؤكد للفعل).
- انتصرَ الحقُّ انتصارًا. (انتصارًا: مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مؤكد للفعل).
- المبين للنوع:
- جرى المتسابقُ جريَ الريحِ. (جريَ: مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مبين لنوع الفعل، وهو مضاف).
- تحدثَ الخطيبُ حديثًا شيقًا. (حديثًا: مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مبين لنوع الفعل).
- المبين للعدد:
- زارَ المريضُ الطبيبَ زيارتينِ. (زيارتينِ: مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، مبين لعدد مرات الفعل).
- سجدَ المصلي سجداتٍ خاشعةً. (سجداتٍ: مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، مبين لعدد مرات الفعل).
الخاتمة
يُعد المفعول المطلق أسلوبًا نحويًا وبلاغيًا فريدًا في اللغة العربية، حيث يأتي مصدرًا منصوبًا مشتقًا من الفعل لتأكيده أو لبيان نوعه أو عدده. فهم أنواع المفعول المطلق ووظائفه المختلفة، وعلامات إعرابه، وحالات حذفه، يُعد ضروريًا لإتقان قواعد النحو العربي والتعبير عن المعاني بدقة وجمالية. إن الاستخدام الواعي والملائم للمفعول المطلق يُثري الأسلوب ويُضفي على الكلام قوة وتأثيرًا خاصًا، ويُعمق فهم المتلقي للحدث وتفاصيله. لذا، فإن العناية بدراسة المفعول المطلق وتطبيقه بشكل صحيح يُعتبر جزءًا هامًا من التمكن من اللغة العربية وفنونها البلاغية.


